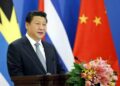بعيدا عن التفصيل العملياتي لضربة الدوحة، إلا أنها تقرأ سياسيا قبل كل شيء وسياسيا هنا لا أعني به الشق المتعلق “بالتمدد الإسرائيلي” العسكري، لكن بسؤال: كيف تستهدف أرض دولة حليفة تستضيف أكبر تموضع جوي أمريكي في المنطقة، من غير أن تنجح واشنطن في منع الفعل أو ردعه؟.
صحيح السؤال يبدو بسيط إلا أنه هو سؤال اللحظة سؤال حول جوهر المعادلة التي بنتها الولايات المتحدة في الخليج منذ الثمانينيات: قواعد وتموضع دائم + شراكات دفاعية = ردع واحترام لسيادة المضيف. إن تزعزعت هذه المعادلة أمام الرأي العام الخليجي، فالسؤال التالي مباشرة سيكون عن قيمة “الضمان” الأمريكي عند احتدام تناقضات الحلفاء.
وضمن هذه المنظومة الأمريكية (العسكرية/الأمنية) في الخليج تلعب الدوحة دورا استثنائيا يعد “عصب التشغيل”.
ليس لأن بها قوات أمريكية فقط، بل لأن على أرضها مركز العمليات الجوية المشتركة CAOC الذي يدير القوة الجوية في مسرح القيادة الوسطى الممتد من شمال أفريقيا إلى جنوب آسيا؛ وذاك يجعل المجال الجوي والسياسي لقطر جزءا من “بنية القيادة والسيطرة” الأمريكية يوميا.
مثلا عام 2021، كانت قاعدة العديد محور إجلاء كابول وتستضيف جناحا جويا كبيرا. هذه المكانة التشغيلية تضع حملا أكبر على ضربة 9 سبتمبر ولماذا يعد أي خرق في الدوحة تصعيدا نوعيا سياسيا يتجاوز “ضربة مركزة” إلى مس بالهندسة الأمنية ذاتها لمنطقة الخليج.
تاريخيا، تبنى العلاقة الأمريكية–الخليجية من طبقات؛ يستحيل فهم الحساسية من دون العودة إلى البدايات الحديثة. منذ عقيدة كارتر (1980) حين أعلنت واشنطن أن أمن الخليج مصلحة حيوية قد تستدعي القوة العسكرية.
بعد تحرير الكويت 1991، ترسخ التموضع الأمريكي الدائم؛ الأسطول الخامس في البحرين، وتموضع بري وجوي في الكويت والإمارات وقطر، ثم صعود الدوحة إلى مركز عمليات متقدم بعد 2001. وفي 2022 رفعت العلاقة إلى مستوى “حليف رئيسي من خارج الناتو” ما يوسع امتيازات التعاون الدفاعي وصفقات التسليح والتشغيل المشترك. هذه السلسلة التاريخية صنعت لدى الخليجيين تصورا بأن الوجود الأمريكي ليس فقط لمواجهة خصوم إقليميين؛ بل أيضا لضبط سلوك الحلفاء المتنافرين ومنع الاشتباك على أراضيهم. ولهذا تخدش الضربة الإسرائيلية هذا التصور إن لم تكن طعنته في مقتل.
المؤكد طبعا أن هذا الحدث—بحد ذاته— لن يؤدي إلى قطيعة مع واشنطن؛ شبكة المصالح أعقد، فيها أمن طرق التجارة والطاقة، التدريب والتسليح، حماية الممرات البحرية التي يديرها الأسطول الخامس من البحرين، والتشابك الاقتصادي/التقني.
لكن المرجح هو إعادة تفكير على الأقل مسارات متزامنة بالتنسيق مع واشنطن منها مثلا؛ تشديد صريح على حرمة السيادة ووضع بروتوكولات جديدة (أمس ترمب أشار في بيانه بتوجيهه لوزير الخارجية ماركو روبيو باستكمال اتفاقية التعاون الدفاعي مع الدوحة. للعلم هناك اتفاقية أصلا لكن يبدو أنها ستحدث).
مع ترمب لا ضمانات صارمة لكن على الأقل الاستفادة قدر الإمكان.
طني أن الخليج يتعلم من التجارب ويوظفها ضمن خياراتها العملية، بعد ضربة أرامكو في 2019 وتخلي ترمب عن الرياض، منذ تلك اللحظة، تحول مسار الأمن السعودي من الاعتماد الكلي إلى الموازنة، سعيا لسد ثغرات الدفاع الجوي والمضاد للمسيرات، وتسريع توطين الصناعات الدفاعية تحت رؤية 2030، والأبرز الحقيقة كان فتح قنوات خفض التصعيد الإقليمي (اتفاق مع طهران لاحقا)، مع إبقاء واشنطن شريكا محوريا لكن خلق مسار مواز ضمن نطاق الإقليم ليس شرطا أن يكون عسكريا لكن في هذه الحالة كان دبلوماسي.
الخوف الحقيقي هو ما سيترتب إن ترسخت سابقة الدوحة.
إذا ترك الانطباع بأن ضربة على أرض حليف وثيق مرت بلا خطوط حمراء واضحة، ستتغير “المعادلة غير المكتوبة” التي حكمت عقودا؛ أن القواعد الأمريكية تضفي مناعة سياسية على أراضي المضيف ضد أفعال طرف ثالث، صديقا كان أو خصما.
تآكل هذه المناعة يعني آثار استراتيجية:
-تتعامل قطر وأي وسيط دبلوماسي بحذر أكبر مع ملفات مثل التهدئة أو تبادل الأسرى إذا شعروا أن أراضيهم ليست بمنأى عن الانتهاك حتى وهم يؤدون دور الوساطة.
-أي مسار تقارب خليجي–إسرائيلي سيتطلب ضمانات سيادية أعلى، وربما أثمانا سياسية داخلية لتعويض الحساسية الشعبية.
-النقطة الأخيرة، هو غياب أي بديل دولي قادر على لعب دور عسكري في المنطقة. بعد ضربة الأمس كان من المفترض أن تكون المعادلة هو أن كل تآكل في صورة “المظلة” يفتح نافذة لموسكو وبكين لتسويق بدائل تموضع أو تسليح انتقائي -ولو على المدى الطويل- ما يضغط واشنطن لتقديم حزم ضمان أوسع. لكن الحقيقة أن لا موسكو ولا بكين لديهم القدرة العسكرية على ملء أي فراغ أمريكي ناهيك عن أنه الولايات المتحدة وجودها ترسخ في المنطقة بجهد سنوات وليس نفوذ سريع كما تحب بكين المكاسب السريعة.