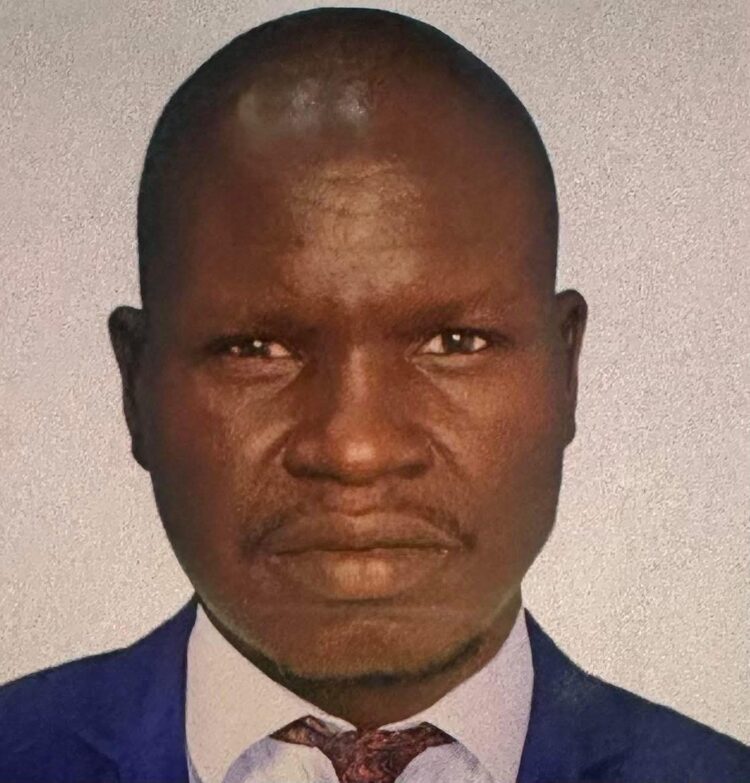منذ أكثر من عقدين من الزمان، تقف دارفور في قلب العاصفة السودانية الإقليم الغني بالثقافة والتنوع، الفقير بالإنصاف والتنمية. اندلع الصراع هناك في عام 2003، ورفع شعار العدالة والمساواة، لكنه مع مرور الوقت تحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والعسكرية بين المركز والهامش، ثم بين أبناء الإقليم أنفسهم.
واليوم، ومع الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعود دارفور إلى واجهة المأساة من جديد، ولكن هذه المرة كـ”ضحية مزدوجة”: بين قوتين تتنازعان الخرطوم، وبين ذاكرة جرح لم يندمل منذ عشرين عامًا.
أولًا: انقسام القضية بين البندقية والمصلحة
منذ اللحظة الأولى، افتقدت الحركات المسلحة في دارفور إلى الرؤية الفلسفية العميقة التي تجعل من القضية مشروعًا وطنيًا شاملًا. فبدل أن تُنتج هذه الحركات فكرًا سياسيًا متماسكًا يؤسس لعلاقة عادلة مع المركز، انشغلت بخطابات أيديولوجية متناقضة.
بعضها رفع شعار العلمانية والتحرر من مركزية الخرطوم، بينما احتمت أخرى بخطاب إسلامي احتجاجي لا يختلف في جوهره عن فكر الدولة التي تعارضها. وبين هذين التيارين، ضاعت دارفور بين البندقية والمصلحة، وفقدت البوصلة الفكرية التي تجعلها فاعلًا في صناعة مستقبل السودان، لا مجرد ورقة في موازنات الصراع.
ثانيًا: المشاركة في حرب لا تشبه دارفور
حين قرر أبناء الإقليم الانخراط في ما يُعرف بـ”القوة المشتركة” إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، بدت الخطوة وكأنها عودة إلى المربع الأول: استخدام دارفور في معركة لا تخصها مباشرة.
لقد صمت الجيش طويلًا على مطالبهم، ثم تخلّى عنهم في لحظة حرجة، ليُتركوا يواجهون مصيرهم أمام قوات الدعم السريع التي استولت مؤخرًا على مواقعهم.
إنّ ما حدث ليس مجرد خطأ تكتيكي، بل إعادة إنتاج لذات الخديعة التاريخية التي جعلت أبناء دارفور وقودًا في حروب الآخرين، ثم ضحايا في مفاوضات السلام.
ثالثًا: إخفاق القيادات وفقدان المشروع
لم ينجح عبد الواحد محمد نور في تحويل قضيته إلى مشروع جامع يتجاوز قبيلة الفور، ولا استطاع منّي أركو مناوي أن يصوغ رؤية سياسية متكاملة تعيد تعريف دارفور داخل الدولة السودانية. أما الراحل خليل إبراهيم، رغم شعبيته وكاريزماه، فقد ظلّ أسير الطرح الإسلامي المرتبط بذاكرة النظام الذي ثار عليه.
وهكذا ظلّت دارفور أسيرة قياداتها، تتحرك بإيقاع الزعامات لا بإرادة الشعب. بينما الحركات الكثيرة التي انشقت عنها فقدت المضمون الوطني وتحولت إلى أدوات مساومة في محاصصات السلطة.
رابعًا: دارفور في معادلة السلطة الجديدة
اليوم، ومع بروز خطاب “التأسيس الجديد” للسودان، يبدو أن دارفور مهددة بأن تُهمّش مرة أخرى، هذه المرة عبر الخطاب الإثني الضيق الذي يضعها على هامش مشروع الدولة المركزية الجديدة.
فالمخاطر ليست فقط في الحرب، بل في ما بعدها — حين تُكتب الخرائط السياسية من جديد، ويُعاد تعريف من هو “السوداني الكامل”، ومن يبقى مواطنًا من الدرجة الثانية.
#رؤية نحو الحل
لن تنتهي مأساة دارفور بإسكات البنادق أو توقيع اتفاق سلام جديد، لأن جوهر الأزمة ليس عسكريًا، بل فكريًا وهيكليًا.
إن الحل المستقبلي لقضية دارفور وبالتالي لمستقبل السودان ككل يتطلب تحولًا جذريًا في ثلاثة مستويات:
- مستوى الفكرة:
يجب أن تنتقل الحركات الدارفورية من منطق “الثأر من المركز” إلى منطق “إعادة تعريف المركز”. أي أن تطرح مشروعًا وطنيًا يُعيد بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة لا على أساس الجغرافيا أو القبيلة. - مستوى القيادة:
تحتاج دارفور إلى جيل جديد من القادة المثقفين، لا أمراء الحرب. قادة يملكون رؤية سياسية متوازنة، قادرة على التفاوض والتفكير، لا على إطلاق النار فقط. - مستوى التنمية والعدالة الانتقالية:
يجب أن تُوضع خطة اقتصادية شاملة لإعادة إعمار الإقليم، وإعادة اللاجئين والنازحين إلى قراهم، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين سواء من الحكومة أو الحركات أو الميليشيات.
إنّ دارفور ليست قضية جغرافية، بل قضية هوية وعدالة. وإذا لم تُحل هذه المعادلة على أسس فكرية وإنسانية عميقة، فستظل دارفور الخاسر الدائم في صراع لا ينتهي، وسيظل السودان يدور في الحلقة ذاتها التي بدأت قبل عشرين عامًا.