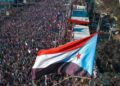علي العارف
في ساعة متأخرة من مساء القاهرة يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير/ كانون الثاني أعلن البنك المركزي الروسي، عبر موقعه الإلكتروني، إدراج 9 عملات جديدة للتداول مقابل الروبل، من بينها الجنيه المصري وهو الخبر الذي لاقي ترحابا رسميا في روسيا قد لا يتوافق مع حجم التجارة البينية لها مع شريك اقتصادي ليس بالكبير كمصر “حجم تجارة يناهز 4 مليارات دولار”، فيما تجنبت القنوات الرسمية للنظام السياسي والمصرفي المصري التعليق على الأمر. هذا وقد اكتفي المحللون الاقتصاديون بالحديث عن المنافع المترتبة على التبادل بالعملات المحلية بين مصر وروسيا والعوائد الاقتصادية التي قد تجنيها القاهرة من ذلك التحرك والذي بلا شك لم يأت بين عشية وضحاها، بل كان وليد مباحثات ثنائية اقتنع فيها كلا الطرفين بجدوى الاتفاق. ولربما كانت موافقة مجلس الوزراء المصري مطلع ديسمبر الماضي على الانضمام لبنك التنمية الجديد «NDB» التابع لمجموعة البريكس التي تشكل روسيا مع الصين حجر الزاوية فيها أحد ارهاصات ذلك الاتفاق.
اقتصر تعليق الاقتصاديين في مصر على قرار المركزي الروسي على الحديث عن مدى إمكانية أن يساهم ذلك في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، و أيضا تخفيف الطلب على الدولار، ودعم حركة السياحة الروسية الوافدة لمصر، ولكن لماذا تجنب النظام المصري الحديث عن الاتفاق الذي قد يساعده على الخروج من أتون الأزمة النقدية الطاحنة التي تعصف بعملته؟ لعل الإجابة تكمن في التبعات السياسية الثقيلة التي قد تترتب ع على الأطراف الثلاثة للخطوة، فالمعادلة ليست قاصرة على روسيا ومصر أصحاب العملات الوطنية التي سوف تستخدم، ولكنه يمتد للدولة صاحبة العملة المستبعدة “أمريكا” وهو الشق الذي أغفله المحللون.
فروسيا المتورطة في حرب كارثية على المستويات الإنسانية والسياسية والعسكرية، تخوض معركة ليست أقل ضراوة على المستوي الاقتصادي بهدف خنقها وتركيعها عبر العقوبات التي تفرضها مختلف الدول الغربية التي جمدت نحو 40 في المئة من الاحتياطي النقدي الروسي. فرض الغرب عقوبات تستهدف النظام المالي والنقدي عبر طرد البنوك الروسية من نظام سويفت وحظر التمويل العام والاستثمارات في روسيا. العقوبات استهدفت أيضاً فرض حظر على صادرات روسيا من النفط والغاز ووضع سقف سعري لمنعها من تحقيق عوائد اقتصادية تدعمها في الحرب ضد أوكرانيا. وهنا يمكننا القول إن الترحاب الروسي يأتي من رمزية الاتفاق مع مصر والذي يعني أن موسكو ما تزال قادرة على إيجاد أسواق لبضائعها بخاصة الحبوب و تحديدا لدي كبار المشترين بعد أن نجحت في الترويج لمنتجاتها في قطاع الطاقة عبر الاتجاه للهند وتركيا والصين لإيجاد بديل عن السوق الأوروبي.
أما مصر فإذا ما أردنا أن نصف الوضع الاقتصادي بعبارات بسيطة فسيكون أزمة نقدية خانقة مع عجز الدولة عن توفير العملات الصعبة، وعجز متنام رقميا بالموازنة، وركود اقتصادي، وفشل في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة التي تم تخفيضها أربع مرات خلال أقل من ثمانية أعوام، كل ذلك بالتزامن مع انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك حتى بلغ نحو سالب 23 مليار دولار. تعطينا الأرقام لمحة أوضح عن حجم الأزمة، حيث بلغت الفجوة بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات نحو 30.18 مليار دولار بمشروع موازنة العام المالي الحالي دون احتساب أقساط الديون، فيما تُمثِّل أقساط الديون وفوائدها نحو 90 مليار دولار وهو ما نسبته 54% من إجمالي الإنفاق العام، لذلك فمصر حريصة على عقد ذلك الاتفاق مع الجانب الروسي لتقليل العجز في ميزانها التجاري بالدولار وترحيل بعض العجز لعملات أخرى من بينها الروبل والروبية والإيوان أملا في حدوث تحسن لميزان المعاملات سواء عبر نجاح الحكومة في بيع عدد من أصول الدولة المصرية لصناديق الاستثمار الخليجية أو عبر عودة الاستقرار لسوق بيع السندات السيادية “الأموال الساخنة” وهي الأداة التمويلية التي طالما أدمنها النظام المصري الحاكم في أخر عشر سنوات.
أما الطرف الثالث في المعادلة فهي الولايات المتحدة الأمريكية وهي بالتأكيد لن تنظر بعين الرضى للمساعي المصرية رغم تفهمها للضغوط الاقتصادية التي دفعتها لذلك. في كتابه الشهير «بلا منازع، لماذا ستبقى أمريكا القوة العظمى الوحيدة في العالم»، ذكر الكاتب الأمريكي مايكل بيكلى أن أحد أهم أسباب سيطرة أمريكا على العالم هو الدولار. فمع اقتراب انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، بادرت حكومتها إلى دعوة 44 دولة للاجتماع في يوليو/تموز 1944 بمدينة بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير للاتفاق على نظام نقدي دولي جديد، بغية تأمين الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي وقد التزمت الولايات المتحدة أمام المصارف المركزية للدول الأعضاء بتبديل حيازتها من الدولارات الورقية بالذهب وعلى أساس سعر محدد وثابت وهو 35 دولاراً للأونصة، وبذلك تساوى الدولار بالذهب في السيولة والقبول العام به احتياطياً دولياً حتي عام 1974، حين اكتشفت عدة دول إصدار الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات دون غطاء ذهبي لتمويل حروبها الخارجية في كوريا وفيتنام، لذلك اتجهت تلك الدول سريعا لاستبدال حيازاتها من الدولار بالذهب وهو ما دفع الفدرالي الأمريكي لإعلان تخليه عن الاتفاقية من جانب واحد، لتبدأ العملة الأمريكية في فقد جزء من قيمتها ويرتفع التضخم وكذلك معدلات البطالة وأخذ الاقتصاد الأمريكي في التدهور بشكل سريع حتي وافقت الحكومة السعودية على عقد اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لتسعير كافة صادرات السعودية النفطية بالدولار. شملت الصفقة في حينها شراء السعودية سندات خزينة أمريكية. وبسبب ثقل هذه الخطوة، سار الخليج على خطي السعودية وعلى نفس النهج مضت باقي الدول المنتجة للنفط، وأصبح العالم يسعر البترول بالدولار، وعليه احتفظت كثير من الدول باحتياطات أجنبية بالدولار لشراء النفط وهو ما أعاد للعملة الأمريكية رونقها وسمح للولايات المتحدة بضخ المزيد من الدولارات في شرايين الاقتصاد العالمي ، من جهة لتلبية الطلب المتزايد على عملتها، ومن جهة أخرى لتمويل الوسائل التي سمحت لها بأن تبقي الأمة الأقوى على مدار قرابة قرن من الزمان. وهنا يمكننا القول إن ما يعرف بالبترودولار يعد أمرا أساسيا في صناعة الهيمنة والتفوق الأمريكي وأن أي تغيير في هذه المعادلة سيعني أمورا أعمق تتعلق بالشق الجيوسياسي وتتعدى الجانب الاقتصادي.
بالطبع التحرك المصري نحو التبادل التجاري بالعملات المحلية مع روسيا والبحث في إمكانية عقد اتفاقيات مماثلة مع الهند والصين سيكون خطرا على الهيمنة الأمريكية العالمية بقدر ما قد يكون ملهما للبلدان الخليجية -المتحفزة بالفعل- والتي قد تتطلع لخطوات مماثلة بخاصة مع تكرار الحماقة الأمريكية في فرض عقوبات قاسية على دول “العراق وليبيا قديما وحاليا إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا” عبر استخدام الدولار ونظام التحويلات الدولية سويفت فيما عرف بتسليح الدولار. وبالنظر للتاريخ نجد أن الدولار يعد البقرة المقدسة للدولة الامريكية وهي تبادر بإسقاط أي نظام حاكم يتجرأ على بيع البترول بعملة خلاف الدولار منذ نظام الدكتور محمد مصدق في إيران مرورا بهواري بو مدين في الجزائر وليس انتهاء بصدام حسين والقذافي وهوجو تشافيز وجميعهم إما قتلوا أو ماتوا في ظروف غامضة.
وطبقا لأرقام منظمة التجارة العالمية فإن قيمة صادرات النفط العالمية يمكن أن تبلغ خلال العام الحالي 2.6 تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تتطلب وجود سيولة كبيرة من العملة التي تستخدم في تجارة هذه السلعة وهو ما دفع دول العالم للاحتفاظ باحتياطيات من تلك العملة فاقت 12 ترليون دولار، وفي حال أن وجدت تلك الدول إمكانية لاستبدال الدولار بعملات أخرى لشراء الوقود فستسعي دون شك لتنويع محفظتها النقدية بعملات أخرى بديلة وهو ما سيعني ضعف الطلب على الدولار وبالتالي تخفيض قيمته وهو ما سيرفع التضخم في أمريكا بمقدار تخلي الدول عنه وأيضا سيدفع الفيدرالي لرفع الفائدة علي العملة مما سيفاقم من أزمة الديون الأمريكية التي تجاوزت حاجز 31.4 ترليون دولار وهو ما جعلها تتربع على عرش الدول الأكثر مديونية على مستوي العالم من حيث القيمة ومن بين الأعلى كنسبة للناتج المحلي مما يجعل من إمكانية رفع العوائد على السندات انتحارا حتميا.
لن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية للخطوة المصرية بأن تتم وستسعى جاهدة أن تظل مجرد حبر على ورق تماما كما كانت اتفاقية مبادلة العملة مع الصين في عام 2016 والتي ظلت قاصرة على قيمة التبادل بنحو 2.6 مليار دولار ولم تتبعها أي خطوات لتحرير التجارة البينية من سطوة الدولار، وفي حالة إصرار الدولة المصرية على المضي قدما في تحرير الاقتصاد المصري من تبعيته للدولار والسعي لربط الجنيه بسلة عملات كما أكد محافظ المركزي حسن عبد الله في أكثر من مناسبة، فبالتأكيد ستتعرض القاهرة لحملة من التهديدات قد تفوق ما تعرضت له سابقا في 2019 على لسان وزير الخارجية الأمريكي حينها مايك بومبيو لإجبارها على التخلي عن شراء صفقة المقاتلات الروسية من طراز سو35 وهي صفقة لو تمت كان يمكن أن تغير من ميزان القوى العسكري في الشرق الأوسط، فما بالنا بصفقة اقتصادية قد تفتح الباب لتغيير ميزان القوي على كافة الأصعدة على مستوى العالم. هذه المرة الأمر جد خطير وأمريكا بحاجة شديدة لدولة تجعل منها ذئبا يتعلم منه باقي ثعالب المنطقة الحكمة وليس أسهل من رأس الذئب المصري المترنح تحت الضغوط الاقتصادية.